

اِفْتِـتَاحٌ
الحَمْدُ
للهِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَتُوبُ إِلَيْه
(١-
قوله: [ونتوب إليه] زيادة مدرجة في الحديث الوارد في خطبة الحاجة، والأولى
ذكر الخطبة مع المحافظة على نصها الثابت.
وقد اقتصر المصنف فيها على صدر الخطبة، وورد في نصها بعد قوله: "وأشهد أنَّ
محمدا عبده ورسوله" ذكر الآيات مرتبة في الخطبة على الوجه التالي:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ
تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 102].
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن
نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً
كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ
وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً﴾ [النساء: 1].
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً
سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً﴾
[الأحزاب:70- 71])
وَنَسْتَغْفِرُهُ، [وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا،
وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا]
(٢-
ما بين المعقوفتين ساقط من نص المصنف)
مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ
هَادِيَ لَهُ، وَنَشْهَدُ
(٣-
أورد المصنف الفعل في الشهادتين بصيغة الجمع، وهو خلاف المنصوص عليه في
الأحاديث المثبتة لها بصيغة المتكلم المفرد، فالأفعال في نص الأحاديث وردت
بصيغة الجمع ما عدا الشهادتين قال ابن القيم رحمه الله في "تهذيب السنن"
(6/149): [ "والأحاديث كلها متفقة على أنَّ: "نستعينه ونستغفره ونعوذ به"
بالنون، والشهادتان بالإفراد، "وأشهد أن لا إله إلاَّ الله، وأشهد أنَّ
محمدا عبده ورسوله".
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "لما كانت كلمة الشهادة لا يتحملها أحد عن أحد،
و لاتقبل النيابة بحال أفرد الشهادة بها، ولما كانت الاستعانة والاستعاذة
والاستغفار يقبل ذلك فيستغفر الرجل لغيره، ويستعين الله له، ويستعيذ بالله
له، أتى فيها بلفظ الجمع، ولهذا يقول: "اللهم أعنا، وأعذنا، واغفر لنا. قال
ذلك في حديث ابن مسعود، وليس فيه "نحمده"، وفي حديث ابن عباس"نحمده"
بالنون ، مع أنَّ الحمد لا يتحمله أحد عن أحد، ولا يقبل النيابة، فإن كانت
هذه اللفظة محفوظة فيه إلى ألفاظ الحمد والاستعانة على نسق واحد.
وفيه معنى آخر، وهو أنَّ الاستعانة والاستعاذة والاستغفار طلب وإنشاء،
فيستحب للطالب أن يطلبه لنفسه ولإخوانه المؤمنين، وأمَّا الشهادة فهي إخبار
عن شهادته لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة، وهي خبر يطابق عقد القلب
وتصديقه، وهذا إنما يخبر به الإنسان عن نفسه لعلمه بحاله بخلاف إخباره عن
غيره، فإنه إنما يخبر عن قوله ونطقه، لا عن عقد قلبه. والله أعلم])
أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ،
وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
أَمَّا
بَعْدُ:
فَإِنَّ
أَصْدَقَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الهَدْيِ هَدْيُ
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ
الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٍ[font=Traditional Arabic]
(٤-
أخرجه بهذا اللفظ مسلم: 6/153 في الجمعة، باب: خطبته صلى الله عليه وآله
وسلم في الجمعة، وابن ماجه: 1/17 رقم (45)، وأحمد في مسنده برقم(5371)
والبيهقي في الجمعة برقم (6010) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما،
وفي صدره بلفظ: "فإنَّ خير الحديث". وفي رواية أخرى: "وإياكم ومحدثات
الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة" أخرجه أبو داود: 5/15 رقم
(4607) والترمذي: 5/44 رقم (2676) وابن ماجه: 1/16 رقم(42)، وأحمد في مسنده
برقم (17608) من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، قال الترمذي: حديث
حسن صحيح)
نَّارِ (٥-
ما بين المعقوفتين أخرجه النسائي: 3/188-189 في العيدين باب: كيف الخطبة،
من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. والحديث صححه الألباني في: "صحيح
سنن النسائي": 1/512 رقم (1577))]
(٦-
هذه خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمها أصحابه
كما يعلمهم التشهد في الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفتتح
خُطَبه بها، وكان السلف الصالح يقدمونها بين يدي دروسهم، وكتبهم، ومختلف
شئونهم، وقد دأب الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله هذه الصيغة عند
افتتاح مجالسه العلمية العامرة، ودروسه العامة تأسيًّا بالنبي صلى الله
عليه وآله وسلم، ولعل من آثار حصول النفع والفائدة من مجالسه حرصه على
المحافظة عليها، ولا يخفى أنَّ خطبة الحاجة تتضمن الحمد والثناء على الله
بما هو أهله، والتشهد الذي إن خلت الخطبة منه فإنها تعد كاليد المقطوعة
التي لا طائل تحتها على ما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بقوله:
"كل خطبة ليس فيها تشهد، فهي كاليد الجذماء" [أخرجه أبو داود: 5/173،
وأحمد: 2/302-343، والبيهقي في "سننه الكبرى": 3/209 من حديث أبي هريرة رضي
الله عنه، والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود: 3/189، وفي
"السلسلة الصحيحة: 1/115 رقم: 169].
لذلك يستحب المحافظة على نصها في افتتاح الخطب والدروس والمحاضرات، وفي
طلائع الرسائل وصدور الكتب ومقدمة المصنفات، وعند عقود النكاح، تمسكا
بالسنة وعملاً بالهدي المغني عن التعبيرات الكثيرة المختلفة التي يأتي بها
الوعاظ وغيرهم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
).
قَوَاعِدُ
الإِسْلاَمِ
-بَيَانُ
قَوَاعِدِ الإِسْلاَمِ الخَمْسِ مِنَ الآيَاتِ القُرْآنِيَةِ
وَالأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ-
قَالَ
رَسُولُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: "بُنِيَ
الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِِلاَّ
اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ
الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ
البَيْتِ
(٧-
متفق عليه: أخرجه البخاري: 1/49 في الإيمان، باب: دعاؤكم إيمانكم، ومسلم:
1/177 في الإيمان: باب بيان أركان الإسلام، والترمذي: 5/5 في الإيمان، باب:
ما جاء بُني الإسلام على خمس، والنسائي: 8/107 باب: على كم بني الإسلام،
والبغوي في: "شرح السنة": 1/17، باب: بيان الأعمال، من حديث عبد الله بن
عمر رضي الله عنهما.
هذا، وقد وردت في رواية البخاري والنسائي تقديم الحج على الصوم، وعليه بنى
البخاري ترتيبه، لكن وقع في مسلم (1/146) من رواية سعد ابن عبيدة عن ابن
عمر بتقديم الصوم على الحج وفيه: "فقال رجل: الحج وصيام رمضان قال: لا،
صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم" قال
ابن حجر في الفتح: (1/50): "ففي هذا إشعار بأنَّ رواية حنظلة التي في
البخاري مروية بالمعنى")"
(٨-
هذا الحديث هو أحد أركان الإسلام، ودعائمه العظام، وجوامع الأحكام ، إذ هو
أصل في معرفة الدين، ومجمع أركانه التي عليها بني، وبها يقوم، وعليها
اعتماده، وهذه القواعد والأركان منصوص عليها في القرآن الكريم، وليست هي كل
الإسلام، لأنَّ شعب الإيمان كثيرة كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم
أنه قال: "الإيمان بضع وسبعون شعبة" الحديث [أخرجه مسلم: 2/3 وغيره من حديث
أبي هريرة رضي الله عنه]، وإنما خصَّ هذه بالذكر لأهميتها، ولم يذكر معها
الجهاد مع أنه يظهر الدين، ويقمع عناد الكافرين، لأنَّ الجهاد فرض على
الكفاية ولا يتعين إلاَّ في بعض الأحوال بخلاف هذه الخمس فهي فرض دائم لا
يسقط بحال.
والحديث يفيد أنَّ الإسلام عقيدة وعمل، وأنَّ هذه الأركان مرتبطة ومتماسكة،
فمن حققها كاملة كان مسلما كامل الإيمان ومن لم يأت بالشهادتين، أو أنكر
وجوب شيء من الأركان الأربعة، أو امتنع عن فعلها كبرًا وحسدًا أو بغضًا لله
ورسوله أو بغضا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو كافر
بالإجماع. [انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية: 7/302، 609. 10/434. 20/97.
22/40. 35/105].
أما من أقر بوجوبها وأهمل شيئا من الأربعة غير الشهادتين كسلا وتهاونا، أو
انشغالا عنها بأمور أخرى، فهذا موضع خلاف بين العلماء، بين مكفّر لتارك
واحدة من الأربعة، وهو إحدى الروايات عن أحمد وهو مروي عن سعيد بن جبير،
والحسن البصري، والسدي، وغيرهم [تفسير الطبري: 4/21، تفسير القرطبي: 4/153،
كتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القيم: 30].
وبين مكفر لتارك الصلاة والزكاة فقط وهو مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه
وهي الرواية الثانية عن أحمد [انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية: 7/303،
الأحكام السلطانية لأبي يعلى: 246] وذهبت طائفة من أصحاب مالك والشافعي ومن
أصحاب أحمد إلى القول أنه لا يكفر بترك الصلاة، وهي الرواية الثالثة عن
أحمد، لكن المشهور عند جمهور أهل العلم من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي
وأحمد أنه لا يكفر بترك شيء من الأركان الأربعة وهي الرواية الرابعة عن
الإمام أحمد [الأم للشافعي: 1/291، والبيان والتحصيل لابن رشد: 1/475-477،
المغني لابن قدامة: 2/442، شرح مسلم للنووي: 2/70].
وأهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب وإنما أرادوا به المعاصي كالزنا
والشرب، أما المباني المتقدمة ففي تكفير تاركها النزاع السابق)
الكَلاَمُ
عَلىَ القَاعِدَةِ الأُولىَ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا:
أَوَّلاً: لاَ نَجَاةَ لِأَحَدٍ عِنْدَ اللهِ تَعَالىَ إِلاَّ
بِالدُّخُولِ فِي الإِسْلاَمِ
(٩-
وتكملة للقاعدة الأولى أن يضاف إليها بعد قوله: "إلاّ بالدخول في الإسلام"
عبارة: ولزومه له من غير مفارقة حتى الموت، ذلك لأن من عاش على شيء مات
عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، وهذه العبارة المضافة تدل عليها الآية
الثانية التي استشهد بها المصنف رحمه الله) لِقَوْلِهِ تَعَالىَ:
﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً
فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾
(١٠-
آية 85 من سورة آل عمران، ومعنى الآية أن الإسلام هو المنهاج الذي أسلمنا
الله تعالى بالإيمان به، والانقياد له، فهو دين الله تعالى وشريعته، فمن
ابتغى غيره فعمله مردود عليه، وهو معدود من الخاسرين يوم القيامة)
ولقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ
تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾
(١١-
جزء من آية 132 من سورة البقرة، قوله: " فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون" فيه
إيجاز بليغ، والمراد الزموا الإسلام ولا تفارقوه حتى تموتوا، والمراد
بالدين المصطفى في الآية الذي أوصى به يعقوب بنيه،كما أوصى إبراهيم بنيه،
هو ملته التي لا يرغب عنها إلا من سفه نفسه، وهي الملة التي جاء بها محمد
صلى الله عليه وآله وسلم [فتح القدير للشوكاني: 1/145]).
ثَانِيًا:
الإِسْلاَمُ هُوَ دِينُ اللهِ الذِي أَرْسَلَ بِهِ
جَمِيعَ رُسُلِهِ،
لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
﴿إِنَّ
الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ﴾
(١٢-
جزء من آية 19 من سورة آل عمران، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في
"التفسير القيم": (201): [وقد دلّ قوله: "إن الدين عند الله الإسلام" على
أنه دين أنبيائه ورسله وأتباعه من أولهم إلى آخرهم، وأنه لم يكن لله قط ولا
يكون له دين سواه، قال أول الرسل نوح: ﴿فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا
سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللّهِ وَأُمِرْتُ
أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [يونس: 72]، وقال إبراهيم وإسماعيل:
﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً
مُّسْلِمَةً لَّكَ﴾ [البقرة: 128]، ﴿َوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ
وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ
تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُون َ﴾ [البقرة: 132]، وقال يعقوب
لبنيه عند الموت: ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ
إِلَـهَكَ وَإِلَـهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
إِلَـهاً وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: 133]وقال موسى
لقومه:﴿ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم
مُّسْلِمِينَ﴾ [يونس: 84]، وقال الله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى
مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللّهِ قَالَ
الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللّهِ آمَنَّا بِاللّهِ وَاشْهَدْ
بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 52]، وقالت ملكة سبأ: ﴿رَبِّ إِنِّي
ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ﴾ [النمل: 44].
فالإسلام دين أهل السماوات ودين أهل التوحيد من أهل الأرض، لا يقبل الله من
أحد دينا سواه])
،
وَلِقَوْلِهِ تَعَالىَ: ﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيّاً وَلاَ
نَصْرَانِيّاً وَلَكِن كَانَ حَنِيفاً مُّسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ﴾
(١٣-
آية 67 من سورة آل عمران)
، وَلِقَوْلِهِ
تَعَالىَ: ﴿يَحْكُمُ
بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ﴾
(١٤-
جزء من آية 44 من سورة المائدة)
وَلِقَوْلِهِ تَعَالىَ: ﴿وَقَالُواْ
لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى
تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ
صَادِقِينَ
(١٥-
استدل بهذه الآية على لزوم النافي للحكم الدليل كما يلزم المثبت، وهو قول
الأكثرين من الفقهاء والمتكلمين، والصواب أن الاستدلال بالآية على هذا
الحكم لا يصح، لأن الله تعالى لم يطالبهم بدليل النفي المجرد، بل ادعوا
دعوى مضمونها إثبات دخولهم الجنة، وأن غيرهم لن يدخلها، فطولبوا بالدليل
الدال على هذه الدعوى المركبة من النفي والإثبات، وصاحب هذه الدعوى يلزمه
الدليل باتفاق الناس، وإنما الخلاف في النفي المجرد، كما أفصح عن ذلك ابن
القيم-رحمه الله- وحقق مسألة النافي هل عليه دليل؟ حيث يقول – رحمه الله –
في[ بدائع الفوائد: 4/151-152]ما نصه: " إن النفي نوعان: -نوع مستلزم
لإثبات ضد المنفي، فهذا يلزم النافي فيه الدليل، كمن نفى الإباحة فإنه
يطالب بالدليل قطعا، لأن نفيها يستلزم ثبوت ضد من أضدادها، ولا بد من دليل،
وكذلك نفي التعذيب بالنار بعد الأيام المعدودة يستلزم دخول الجنة والفوز
بالنعيم ولابد من دليل.
النوع الثاني: نفي لا يستلزم ثبوتا كنفي صحة عقد من العقود، أو شرط، أو
عبادة في الشرعيات، ونفي إمكان شيء ما من الأشياء في العقليات، فالنافي إن
نفى العلم به، لم يلزمه الدليل، وإن نفى المعلوم نفسه، وادّعى أنه منتف في
نفس الأمر فلا بد له من دليل".)
* بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ
أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ
يَحْزَنُونَ﴾
(١٦-
آية 111-112 من سورة البقرة).
١- قوله: [ونتوب إليه] زيادة مدرجة في الحديث الوارد في خطبة
الحاجة، والأولى ذكر الخطبة مع المحافظة على نصها الثابت.
وقد اقتصر المصنف فيها على صدر الخطبة، وورد في نصها بعد
قوله: "وأشهد أنَّ محمدا عبده ورسوله" ذكر الآيات مرتبة في
الخطبة على الوجه التالي:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ
اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ
وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾ [آل
عمران: 102].
﴿يَا
أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم
مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً
وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ
وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً﴾
[النساء: 1].
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ
لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن
يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً﴾
[الأحزاب:70- 71].
٢- ما بين المعقوفتين ساقط من نص المصنف.
٣- أورد المصنف الفعل في الشهادتين بصيغة الجمع، وهو خلاف
المنصوص عليه في الأحاديث المثبتة لها بصيغة المتكلم
المفرد، فالأفعال في نص الأحاديث وردت بصيغة الجمع ما عدا
الشهادتين قال ابن القيم رحمه الله في "تهذيب السنن" (6/149): [ "والأحاديث كلها متفقة على أنَّ: "نستعينه
ونستغفره ونعوذ به" بالنون، والشهادتان بالإفراد، "وأشهد
أن لا إله إلاَّ الله، وأشهد أنَّ محمدا عبده ورسوله".
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "لما كانت كلمة الشهادة لا
يتحملها أحد عن أحد، و لاتقبل النيابة بحال أفرد الشهادة
بها، ولما كانت الاستعانة والاستعاذة والاستغفار يقبل ذلك
فيستغفر الرجل لغيره، ويستعين الله له، ويستعيذ بالله له،
أتى فيها بلفظ الجمع، ولهذا يقول: "اللهم أعنا، وأعذنا،
واغفر لنا. قال ذلك في حديث ابن مسعود، وليس فيه "نحمده"،
وفي حديث ابن عباس"نحمده" بالنون ، مع أنَّ الحمد لا
يتحمله أحد عن أحد، ولا يقبل النيابة، فإن كانت هذه اللفظة
محفوظة فيه إلى ألفاظ الحمد والاستعانة على نسق واحد.
وفيه معنى آخر، وهو أنَّ الاستعانة والاستعاذة والاستغفار
طلب وإنشاء، فيستحب للطالب أن يطلبه لنفسه ولإخوانه
المؤمنين، وأمَّا الشهادة فهي إخبار عن شهادته لله
بالوحدانية ولنبيه بالرسالة، وهي خبر يطابق عقد القلب
وتصديقه، وهذا إنما يخبر به الإنسان عن نفسه لعلمه بحاله
بخلاف إخباره عن غيره، فإنه إنما يخبر عن قوله ونطقه، لا
عن عقد قلبه. والله أعلم].
٤- أخرجه بهذا اللفظ مسلم: 6/153 في
الجمعة، باب: خطبته صلى الله عليه وآله وسلم في الجمعة،
وابن ماجه: 1/17 رقم (45)، وأحمد في مسنده برقم(5371) والبيهقي في الجمعة برقم (6010) من حديث جابر بن عبد الله
رضي الله عنهما، وفي صدره بلفظ: "فإنَّ خير الحديث". وفي
رواية أخرى: "وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة،
وكل بدعة ضلالة" أخرجه أبو داود: 5/15 رقم (4607)
والترمذي: 5/44 رقم (2676) وابن ماجه: 1/16 رقم(42)، وأحمد
في مسنده برقم (17608) من حديث العرباض بن سارية رضي الله
عنه، قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
٥- ما بين المعقوفتين أخرجه النسائي:
3/188-189 في العيدين باب: كيف الخطبة، من حديث جابر بن
عبد الله رضي الله عنهما. والحديث صححه الألباني في: "صحيح
سنن النسائي": 1/512 رقم (1577).
هذا، وللمحدث ناصر الدين الألباني رسالة قيمة في خطبة
الحاجة تتبع طرقها وألفاظها من مختلف السنة المطهرة، وذكر
جملة من فوائدها، وآخر طبعة للرسالة تولتها مكتبة المعارف
للنشر والتوزيع بالرياض، سنة: 1421ﻫ/2000م.
٦- هذه خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم يعلمها أصحابه كما يعلمهم التشهد في الصلاة، وكان
النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفتتح خُطَبه بها، وكان
السلف الصالح يقدمونها بين يدي دروسهم، وكتبهم، ومختلف
شئونهم، وقد دأب الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله هذه
الصيغة عند افتتاح مجالسه العلمية العامرة، ودروسه العامة
تأسيًّا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولعل من آثار
حصول النفع والفائدة من مجالسه حرصه على المحافظة عليها،
ولا يخفى أنَّ خطبة الحاجة تتضمن الحمد والثناء على الله
بما هو أهله، والتشهد الذي إن خلت الخطبة منه فإنها تعد
كاليد المقطوعة التي لا طائل تحتها على ما أخبر به المصطفى
صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: "كل خطبة ليس فيها تشهد،
فهي كاليد الجذماء" [أخرجه أبو داود: 5/173، وأحمد:
2/302-343، والبيهقي في "سننه الكبرى": 3/209 من حديث أبي
هريرة رضي الله عنه، والحديث صححه الألباني في صحيح سنن
أبي داود: 3/189، وفي "السلسلة الصحيحة: 1/115 رقم: 169].
لذلك يستحب المحافظة على نصها في افتتاح الخطب والدروس
والمحاضرات، وفي طلائع الرسائل وصدور الكتب ومقدمة
المصنفات، وعند عقود النكاح، تمسكا بالسنة وعملاً بالهدي
المغني عن التعبيرات الكثيرة المختلفة التي يأتي بها
الوعاظ وغيرهم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله
وسلم.
٧- متفق عليه: أخرجه البخاري: 1/49 في الإيمان، باب: دعاؤكم
إيمانكم، ومسلم: 1/177 في الإيمان: باب بيان أركان
الإسلام، والترمذي: 5/5 في الإيمان، باب: ما جاء بُني
الإسلام على خمس، والنسائي: 8/107 باب: على كم بني
الإسلام، والبغوي في: "شرح السنة": 1/17، باب: بيان
الأعمال، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
هذا، وقد وردت في رواية البخاري والنسائي تقديم الحج على
الصوم، وعليه بنى البخاري ترتيبه، لكن وقع في مسلم (1/146) من رواية سعد ابن عبيدة عن ابن عمر بتقديم الصوم
على الحج وفيه: "فقال رجل: الحج وصيام رمضان قال: لا، صيام
رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم" قال ابن حجر في الفتح: (1/50): "ففي هذا إشعار
بأنَّ رواية حنظلة التي في البخاري مروية بالمعنى".
٨- هذا الحديث هو أحد أركان الإسلام، ودعائمه العظام، وجوامع
الأحكام ، إذ هو أصل في معرفة الدين، ومجمع أركانه التي
عليها بني، وبها يقوم، وعليها اعتماده، وهذه القواعد
والأركان منصوص عليها في القرآن الكريم، وليست هي كل
الإسلام، لأنَّ شعب الإيمان كثيرة كما ثبت عنه صلى الله
عليه وآله وسلم أنه قال: "الإيمان بضع وسبعون شعبة" الحديث
[أخرجه مسلم: 2/3 وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه]،
وإنما خصَّ هذه بالذكر لأهميتها، ولم يذكر معها الجهاد مع
أنه يظهر الدين، ويقمع عناد الكافرين، لأنَّ الجهاد فرض
على الكفاية ولا يتعين إلاَّ في بعض الأحوال بخلاف هذه
الخمس فهي فرض دائم لا يسقط بحال.
والحديث يفيد أنَّ الإسلام عقيدة وعمل، وأنَّ هذه الأركان
مرتبطة ومتماسكة، فمن حققها كاملة كان مسلما كامل الإيمان
ومن لم يأت بالشهادتين، أو أنكر وجوب شيء من الأركان
الأربعة، أو امتنع عن فعلها كبرًا وحسدًا أو بغضًا لله
ورسوله أو بغضا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
فهو كافر بالإجماع. [انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية:
7/302، 609. 10/434. 20/97. 22/40. 35/105].
أما من أقر بوجوبها وأهمل شيئا من الأربعة غير الشهادتين
كسلا وتهاونا، أو انشغالا عنها بأمور أخرى، فهذا موضع خلاف
بين العلماء، بين مكفّر لتارك واحدة من الأربعة، وهو إحدى
الروايات عن أحمد وهو مروي عن سعيد بن جبير، والحسن
البصري، والسدي، وغيرهم [تفسير الطبري: 4/21، تفسير
القرطبي: 4/153، كتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القيم: 30].
وبين مكفر لتارك الصلاة والزكاة فقط وهو مروي عن ابن مسعود
رضي الله عنه وهي الرواية الثانية عن أحمد [انظر: مجموع
الفتاوى لابن تيمية: 7/303، الأحكام السلطانية لأبي يعلى:
246] وذهبت طائفة من أصحاب مالك والشافعي ومن أصحاب أحمد
إلى القول أنه لا يكفر بترك الصلاة، وهي الرواية الثالثة
عن أحمد، لكن المشهور عند جمهور أهل العلم من أصحاب أبي
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أنه لا يكفر بترك شيء من
الأركان الأربعة وهي الرواية الرابعة عن الإمام أحمد [الأم
للشافعي: 1/291، والبيان والتحصيل لابن رشد: 1/475-477،
المغني لابن قدامة: 2/442، شرح مسلم للنووي: 2/70].
وأهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب وإنما أرادوا به
المعاصي كالزنا والشرب، أما المباني المتقدمة ففي تكفير
تاركها النزاع السابق.
٩-
وتكملة للقاعدة الأولى أن يضاف إليها بعد قوله: "إلاّ
بالدخول في الإسلام" عبارة: ولزومه له من غير مفارقة حتى
الموت، ذلك لأن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء
بعث عليه، وهذه العبارة المضافة تدل عليها الآية الثانية
التي استشهد بها المصنف رحمه الله.
١٠- آية 85 من سورة آل عمران، ومعنى الآية أن الإسلام هو
المنهاج الذي أسلمنا الله تعالى بالإيمان به، والانقياد
له، فهو دين الله تعالى وشريعته، فمن ابتغى غيره فعمله
مردود عليه، وهو معدود من الخاسرين يوم القيامة.
١١- جزء من آية 132 من سورة البقرة، قوله: " فلا تموتن إلا
وأنتم مسلمون" فيه إيجاز بليغ، والمراد الزموا الإسلام ولا
تفارقوه حتى تموتوا، والمراد بالدين المصطفى في الآية الذي
أوصى به يعقوب بنيه،كما أوصى إبراهيم بنيه، هو ملته التي
لا يرغب عنها إلا من سفه نفسه، وهي الملة التي جاء بها
محمد صلى الله عليه وآله وسلم [فتح القدير للشوكاني: 1/145].
١٢- جزء من آية 19 من سورة آل عمران، قال ابن القيم رحمه الله
تعالى فيما جمع له في "التفسير القيم": (201): [color=#cc0000]"إن
الدين عند الله الإسلام" على أنه دين أنبيائه ورسله
وأتباعه من أولهم إلى آخرهم، وأنه لم يكن لله قط ولا يكون
له دين سواه، قال أول الرسل نوح: ﴿فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم
مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللّهِ
وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [يونس:
72]، وقال إبراهيم وإسماعيل: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ
لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ﴾ [البقرة:
128]، ﴿َوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ
وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ
الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُون َ﴾
[البقرة: 132]، وقال يعقوب لبنيه عند الموت:
﴿مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَـهَكَ
وَإِلَـهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
وَإِسْحَاقَ إِلَـهاً وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة:
133]وقال موسى لقومه:﴿
إِن
كُنتُمْ آمَنتُم بِاللّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن
كُنتُم مُّسْلِمِينَ﴾ [يونس:
84]، وقال الله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ
الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللّهِ قَالَ
الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللّهِ آمَنَّا بِاللّهِ
وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾
[آل عمران: 52]، وقالت ملكة سبأ: ﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي
وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ﴾
[النمل: 44].
فالإسلام دين أهل السماوات ودين أهل التوحيد من أهل الأرض،
لا يقبل الله من أحد دينا سواه].
١٣- آية 67 من سورة آل عمران.
١٤- جزء من آية 44 من سورة المائدة.
١٥- استدل بهذه
الآية على لزوم النافي للحكم الدليل كما يلزم المثبت، وهو
قول الأكثرين من الفقهاء والمتكلمين، والصواب أن الاستدلال
بالآية على هذا الحكم لا يصح، لأن الله تعالى لم يطالبهم
بدليل النفي المجرد، بل ادعوا دعوى مضمونها إثبات دخولهم
الجنة، وأن غيرهم لن يدخلها، فطولبوا بالدليل الدال على
هذه الدعوى المركبة من النفي والإثبات، وصاحب هذه الدعوى
يلزمه الدليل باتفاق الناس، وإنما الخلاف في النفي المجرد،
كما أفصح عن ذلك ابن القيم-رحمه الله- وحقق مسألة النافي
هل عليه دليل؟ حيث يقول – رحمه الله – في[ بدائع الفوائد:
4/151-152]ما نصه: " إن النفي نوعان: -نوع مستلزم لإثبات
ضد المنفي، فهذا يلزم النافي فيه الدليل، كمن نفى الإباحة
فإنه يطالب بالدليل قطعا، لأن نفيها يستلزم ثبوت ضد من
أضدادها، ولا بد من دليل، وكذلك نفي التعذيب بالنار بعد
الأيام المعدودة يستلزم دخول الجنة والفوز بالنعيم ولابد
من دليل.
النوع الثاني: نفي لا يستلزم ثبوتا كنفي صحة عقد من
العقود، أو شرط، أو عبادة في الشرعيات، ونفي إمكان شيء ما
من الأشياء في العقليات، فالنافي إن نفى العلم به، لم
يلزمه الدليل، وإن نفى المعلوم نفسه، وادّعى أنه منتف في
نفس الأمر فلا بد له من دليل".
١٦-
آية
111-112 من سورة البقرة.
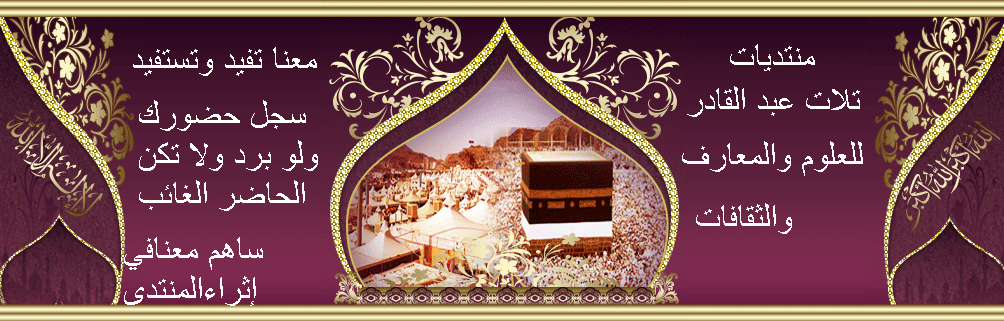






» مشاهير اعتنقوا الاسلام تعرفوا عليهم Celebrities who converted to Islam recognized them
» رسام وشوم في اليابان يزلزل العالم ويعلن إسلامه بعد أن اكتشف سرا خطيرا في ورقة صغيرة
» من الالحاد الى الاسلام
» غرداية
» مشاهير دخلوا الاسلام حديثا 13 من مشاهير العالم اعتنقوا الإسلام عام 2020
» مشاهير اعتنقوا الاسلام تعرفوا عليهم Celebrities who converted to Islam recognized them
» الطريقة الصحيحة للمراجعة لشهادة التعليم المتوسط || الطريق إلى معدل 18 BEM DZ
» طرق المذاكرة للاطفال
» طرق المذاكرة الصحيحة مع الأبناء - 6 طرق ذكية للمذاكرة الصحيحة مع الأطفال
» فيديو نادر: الجزائر قبل 90 سنة
» حقائق حول مقتل محمد شعباني أصغر عقيد في الجزائر-30 يوم تحقيق
» المؤرخ محمد لمين بلغيث يكشف أمور خطيرة عن الحراك و غديري و توفيق
» الجريمة السياسية.. اغتيال الملك فيصل بن عبد العزيز
» ذكرى مؤتمر الصومام و جدلية السياسي و العسكري